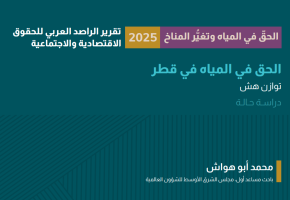استبدال الدين بالطاقة النظيفة: مقاربة نقدية لصفقات العدالة المناخية - زياد عبد الصمد
زياد عبد الصمد
استبدال الدين بالطاقة النظيفة: مقاربة نقدية لصفقات العدالة المناخية - زياد
عبد الصمد
في ظلّ تصاعد أزمات الديون وتفاقم تداعيات تغيّر المناخ، برزت في السنوات
الأخيرة فكرة “استبدال
الدين بالطاقة النظيفة" أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ مبادلة
الدين مقابل العمل المناخي. تقوم هذه الآلية على اتفاق
بين دولة دائنة وأخرى مدينة، تُعفى بموجبه الأخيرة من جزء من ديونها، مقابل
التزامها بتوظيف المبلغ المعفى في مشاريع الطاقة المتجددة أو خفض الانبعاثات. من
حيث المبدأ، تبدو الفكرة مثالية: فهي تخفف الضغط المالي على الدول النامية وتوجّه
مواردها نحو التحول الطاقوي المستدام.
غير أن هذه الصورة الوردية تصطدم بجملة من التحديات البنيوية والسياسية
التي تجعل من هذه المبادلات أداة رمزية أكثر منها استراتيجية فعّالة لإعادة رسم
العلاقة بين الشمال والجنوب في مواجهة الأزمة المناخية.
أول ما يلفت الانتباه هو الخلل البنيوي في ميزان القوة بين الدائن
والمدين. فالدول النامية لا تفاوض من موقع الندّية، بل من موقع الحاجة، مما
يجعل شروط الإعفاء أقرب إلى منحة مشروطة أو آلية رقابية مموّهة. كثير من الصفقات
المناخية المماثلة تتضمن التزامات تفصيلية حول نوع المشاريع، وآليات المراقبة،
وحتى الشركاء المنفذين، ما يُبقي الدول المدينة في دائرة التبعية الاقتصادية
والتكنولوجية للدول الغنية. بمعنى آخر، تتحول المبادلة من فرصة للسيادة البيئية
إلى أداة لإعادة إنتاج التبعية بطريقة “خضراء”.
تضاف إلى ذلك الأسباب البنيوية التي تؤدي إلى تفاقم المديونية،
مثل ضعف الهياكل الاقتصادية، والاعتماد المفرط على مصادر تمويل خارجية غير مستقرة،
خاصة في المنطقة العربية. فمبادلات الدين بالطاقة النظيفة لا تعالج هذه الجذور
الهيكلية، بل تكتفي بتخفيف جزئي للعبء المالي دون تغيير في نمط الاقتصاد أو في
بنية الإنتاج. وفي بعض الحالات، تتحول هذه الصفقات إلى شكل جديد من المشروطية، إذ
تقيّد الفسحة السياسية الوطنية وتفرض أولويات تنموية من الخارج. فماذا لو كانت
حاجة البلد تقتضي توجيه الموارد نحو مكافحة الفقر أو تقليص اللامساواة أو إحداث
تحول هيكلي في الاقتصاد؟
ثمّة أيضًا محدودية في الأثر المالي الفعلي لهذه المبادلات.
فمعظمها لا يشمل سوى جزء صغير من الدين العام، وغالبًا ما يقتصر على ديون ثنائية
أو تجارية محدودة. في حالات مثل الإكوادور وباربادوس، لم يتجاوز حجم الإعفاء نسبة
٢ إلى ٣ في المئة من إجمالي الدين، وهي نسبة رمزية لا تغيّر واقع الأزمة المالية.
والأسوأ أن بعض الدائنين يستخدمون هذه المبادلات كوسيلة لتحسين صورتهم المناخية من
دون تحمّل كلفة حقيقية، إذ يعفون عن ديون متعثّرة أو ميؤوس من تحصيلها أصلًا،
فيقدّمونها على أنها “استثمار أخضر”. بهذا المعنى، يتحول العمل المناخي إلى آلية تجميل
سياسي أكثر منه إصلاحًا اقتصاديًا أو بيئيًا.
وفي المقابل، قد تخلق هذه الأدوات حوافز خاطئة (Wrong Incentives)، إذ تُغري بعض الحكومات على الاقتراض مجددًا
تحت شعار “التمويل المستدام”، ما يؤدي إلى تعميق أزمة الديون بدل معالجتها. بذلك،
تتحول مبادلات الدين إلى مسكنات قصيرة المدى تساهم في استمرار حلقة المديونية بدل
كسرها.
التحدي الثاني يتمثل في ضعف القدرات المؤسسية والفنية في الدول
المدينة. فتنفيذ مشاريع طاقة نظيفة
يحتاج إلى بنى تحتية متطورة، وإدارة شفافة، وكوادر تقنية مؤهلة. في كثير من
الحالات، تعاني هذه الدول من غياب الشفافية، وتداخل المصالح السياسية بالاقتصادية،
مما يجعل تنفيذ المشاريع عرضة للتأخير أو الفساد أو ضعف الأثر التنموي. كما أن غياب
معايير موحّدة لقياس “الأثر المناخي” يجعل من الصعب التحقق من أن الأموال المعفاة
تُستخدم فعلًا في مشاريع خضراء لا في سدّ العجز العام أو دعم النفقات الجارية.
لكن التحدي الأعمق والأقل تناولًا في النقاش العام هو التحوّل من
سياسات تخفيض الاستهلاك إلى بناء قدرة إنتاجية نظيفة. فالكثير من الدول التي
تدخل هذه الصفقات تكتفي بخطط ترشيد استهلاك الطاقة أو تحسين الكفاءة، من دون أن
تمتلك استراتيجية وطنية حقيقية لإنتاج الطاقة المتجددة. الانتقال من مستهلك إلى
منتج للطاقة النظيفة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ونقلًا للتكنولوجيا،
واستقرارًا تشريعيًا طويل الأمد، وهي عوامل نادرًا ما تتوافر في الدول المثقلة
بالديون أو الاضطرابات السياسية. بالتالي، يبقى التحول الطاقوي رهينة التمويل
الخارجي، لا نتاجًا لتخطيط وطني مستدام.
وفي لغة تحميل المسؤوليات في المفاوضات المناخية، يُستخدم تعبير “الديون الكربونية" للدلالة
على مسؤولية الدول المتقدمة عن الانبعاثات المتراكمة في الغلاف الجوي منذ الثورة
الصناعية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الدول تتحمل نحو ٧٠٪ من الانبعاثات
التاريخية التي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن هذا المنطلق، تقع على
عاتقها مسؤولية تعويض الدول النامية عبر نقل التكنولوجيا، وتمويل مشاريع
التخفيف من الانبعاثات وبرامج التكيف مع الكوارث المناخية، إذ تصيب هذه
الأخيرة البلدان الفقيرة بنسبة أعلى من المتقدمة. هذه التعويضات المناخية
المتراكمة قد تفوق في قيمتها حجم الديون التي تتحدث عنها تلك الدول، ما يفرض
مقاربة أكثر عدالة في معالجة الترابط بين الديون والمناخ.
الأخطر أن الدول المتقدّمة تواصل التهرّب من مسؤولياتها في معالجة
أزمة الديون بطريقة عادلة وشاملة، إذ تُصرّ على إبقاء النظام المالي العالمي
على حاله، بحيث تستمر الدول المدينة في سداد فوائد الديون وخدمة الدين
المتراكمة، بينما يبقى أصل الدين قائمًا لعقود. بهذه الطريقة، تتحول خدمة
الدين إلى أداة لاستنزاف الموارد العامة ومنع توجيهها نحو الاستثمار في التنمية
والتحول الطاقوي. من هذا المنظور، يُفترض أن تكون الدول النامية في موقع المتلقّي
لتعويضات مناخية وتمويلات عادلة، لا في موقع المساومة على جزء من ديونها. بعبارة أخرى،
فإن مبادلة الدين بالطاقة النظيفة قد تخفف الضغط المالي مؤقتًا، لكنها لا
تُعالج جوهر الاختلال في النظام المالي والمناخي العالمي.
ثمّة أيضًا إشكالية سياسية تتعلق بالسيادة الوطنية. فالمشاريع
الممولة من هذه المبادلات غالبًا ما تخضع لإشراف مباشر من مؤسسات أو شركات أجنبية،
ما يثير أسئلة حول ملكية الموارد، والتحكم بالسياسات الطاقوية، وتوجيه العائدات.
وفي بعض الحالات، تُستخدم هذه المبادلات لفرض اهداف اقتصادية تتجاوز الهدف البيئي
المعلن، مثل الخصخصة أو فتح الأسواق أمام الشركات الأجنبية بحجة الكفاءة
والاستدامة.
كل ذلك لا يعني أن الآلية بلا جدوى. فمبادلات الدين يمكن أن تشكّل مدخلًا
مفيدًا إذا أُعيد تصميمها على أسس أكثر عدالة وشفافية، بحيث تُمنح الدول
المدينة حرية أكبر في تحديد أولوياتها الطاقوية، مع ضمان نقل فعلي للتكنولوجيا لا
مجرد تمويل محدود. كما ينبغي أن تكون هذه الصفقات جزءًا من استراتيجية
عالمية أشمل لإصلاح هيكل الديون وتمويل المناخ، لا مبادرات متفرقة تخدم
العلاقات العامة للدول الغنية.
في النهاية، يمكن القول إن استبدال الدين بالطاقة النظيفة يمثل فكرة تحمل إمكانًا تحويليًا كبيرًا لكنها تصطدم بواقع اقتصادي غير متكافئ. فحين تُقدَّم كحلّ رمزي دون معالجة اختلالات النظام المالي الدولي أو تمكين الدول النامية من الإنتاج الطاقوي المستقل، تصبح هذه المبادلات مجرد صفقات لتجميل النظام القائم بدل أن تكون خطوة نحو عدالة مناخية ومالية حقيقية. وحده الربط بين الإعفاء المالي، والسيادة التقنية، والالتزام الأخلاقي العالمي بالمسؤولية المشتركة، يمكن أن يحوّل هذه المبادرات من أدوات ضغط إلى جسور تنمية مستدامة تعيد تعريف العلاقة بين الاقتصاد والبيئة في القرن الواحد والعشرين.
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة