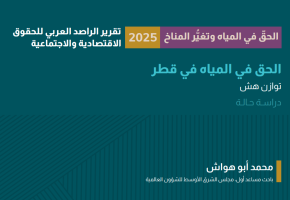الدين العام في الأردن.. جذور الأزمة ومسارات المعالجة - أحمد عوض
يشهد الأردن منذ سنوات مساراً مقلقاً في نمو الدين العام، حيث ارتفع إجمالي المديونية من نحو 29.7 مليار دينار عام 2019 إلى 43.5 ملياراً في 2024، ما يعادل 117.2بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام لا تعكس ظرفاً مؤقتاً بقدر ما تجسد أزمة هيكلية تراكمت عبر سنوات طويلة، ودفعت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي وسياسي متشابك. ضعف القاعدة الإنتاجية، واعتماد الحكومات المتعاقبة على الاقتراض والمساعدات الخارجية، إلى جانب نظام ضريبي غير عادل، جعلت الحكومة عالقة في حلقة مفرغة من العجز والدين والخدمة المتزايدة له والتي تلتهم ربع الإيرادات العامة، فيما لا يتجاوز معدل النمو 2.5 بالمئة والبطالة مستقرة على ارتفاع وعند مستويات مزمنة تصل إلى 22 بالمئة، وتتخطى بين الشباب 40 بالمئة.
المشكلة في جوهرها أن الاقتصاد الأردني لم يتمكن من بناء قاعدة إنتاجية متينة قادرة على خلق النمو المستدام. قطاعات الصناعة والزراعة فقدت الكثير من تنافسيتها، فيما يهيمن قطاع الخدمات منخفض القيمة المضافة، ويعاني تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نقص حاد. الى جانب الأزمات الخارجية المتتالية، من الأزمة المالية العالمية وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مرّت على الاقتصاد الأردني كعواصف متلاحقة، أثرت على التجارة والسياحة وكلفة الطاقة والغذاء، وزادت من هشاشة الوضع الداخلي.
أما النظام الضريبي، فقد بات عبئاً ثقيلاً على المواطن العادي. أكثر من ثلثي الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة، أبرزها الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة المفروضة على الوقود والاتصالات والتبغ، فيما تبقى ضريبة الدخل محدودة التصاعدية وغير فعالة في تحصيل نصيب عادل من أصحاب الدخول المرتفعة والشركات الكبرى. هذا الواقع لا يفاقم فقط الضغوط على الفئات المتوسطة والفقيرة، بل يضعف أيضاً القدرة الشرائية ويُبقي عجلة النمو الاقتصادي في حالة تباطؤ. ومع استمرار العجز المزمن في الموازنة العامة، الذي بلغ في المتوسط 7.4 بالمئة من الناتج المحلي في السنوات الأخيرة، لجأت الحكومات إلى الاقتراض لتغطية النفقات، فتضاعفت خدمة الدين بشكل مقلق من 1.1 مليار دينار عام 2019 إلى نحو ملياري دينار في 2024، مع توقع وصولها إلى 2.2 مليار في 2025. هذا يعني أن الحكومة تدفع في عام واحد فوائد على ديونها بما يوازي تقريباً مجموع إنفاقها على قطاعي التعليم والصحة، وهو مؤشر بالغ الخطورة على اختلال أولويات المالية العامة.
المعضلة لا تتوقف عند الأرقام، بل تمتد إلى المشروطية المرتبطة بالمساعدات والقروض الدولية. كثير من هذه التدفقات المالية يأتي مشروطاً بإجراءات مالية تقشفية، من رفع الضرائب غير المباشرة إلى خفض الدعم وتقليص الإنفاق الجاري. ومع ارتباط الدينار بالدولار، يجد الأردن نفسه تحت رحمة السياسة النقدية الأمريكية، حيث يؤدي رفع الفائدة في واشنطن إلى ارتفاع كلفة الاقتراض وضغوط إضافية على الاحتياطيات. وهكذا يتضاعف عبء الدين الخارجي وتزداد هشاشة المالية العامة. انعكاسات هذه السياسات كانت قاسية اجتماعياً. فإجراءات التقشف المالي لم تُواكب بإصلاحات عادلة، والبطالة المرتفعة مع الأجور الجامدة أدت إلى اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية. الكثير من الأردنيين باتوا يعتمدون على الاقتصاد غير المنظم لتأمين رزقهم، فيما تتراجع جودة بعض الخدمات العامة الأساسية وعلى وجه الخصوص التعليم والرعاية الصحية والسكن، وتتراجع ثقة الناس بالمؤسسات. بذلك يصبح الدين العام ليس مجرد مشكلة مالية، بل قضية مجتمعية وسياسية تمس الاستقرار على المدى البعيد.
معالجة هذه الأزمة تتطلب إعادة بناء العقد المالي والاجتماعي على أسس جديدة. البداية تكون بإصلاح ضريبي عادل يخفف الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، ويجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، ويضع ضرائب على الثروة والأصول الكبيرة. هذا من شأنه أن يوفر إيرادات مستدامة ويعيد توزيع العبء بشكل أكثر إنصافاً. إلى جانب ذلك، لا بد من مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج تدريجي ومنظم للقطاع غير الرسمي، ولعل تطبيق نظام الفوترة الالكتروني هذا العام يعد خطوة هامة في هذا المجال، مع تبسيط الإجراءات وتشجيع الامتثال.
في جانب الإنفاق، المطلوب التحول من
الإنفاق الجاري غير المنتج إلى الاستثمار في المشاريع التي تخلق قيمة مضافة وفرص
عمل، مثل الصناعات التحويلية الخضراء، والزراعة الحديثة، وسلاسل التوريد، والخدمات
اللوجستية، وهي مجالات قادرة على دفع النمو إذا ما توفرت لها الاستثمارات اللازمة.
كذلك يجب إعادة الاعتبار للتعليم والصحة باعتبارهما استثماراً أساسياً، وضمان أن
لا تتحول هذه القطاعات إلى مجال للخصخصة الصامتة التي تحرم الفئات الأضعف من
حقوقها الأساسية.
أما القطاع الخاص، فلا بد من سياسات تعزز دوره المنتج بعيداً عن الريع والمضاربة. الحوافز الائتمانية الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أدوات تمويل بديلة مثل سوق سندات الشركات والتمويل التشاركي، ومراجعة سياسات البنوك التي تفضل إقراض الحكومة على حساب المشاريع الإنتاجية، كلها خطوات ضرورية. على موازاة ذلك، لا بد من سياسات نشطة لسوق العمل تربط التدريب بالطلب الفعلي وتدفع نحو رفع الأجور وتحسين معايير العمل بما يحفز الإنتاجية والطلب المحلي.
الخلاصة أن أزمة الدين في الأردن
ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة خيارات وسياسات يمكن تصحيحها. المطلوب إعادة
الاعتبار للعدالة الضريبية، توجيه الإنفاق نحو استثمارات حقيقية، تنشيط القطاع
الخاص المنتج، وتعزيز الشفافية والمساءلة. هذه ليست وصفة سهلة، لكنها الطريق الوحيد
للخروج من الحلقة المفرغة، وتحويل الدين من عبء يثقل الحاضر إلى أداة تدعم التنمية
وتفتح أفقاً لمستقبل أفضل.
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة