
صيدليات الأرض المحاصَرة: كيف تصنع نساؤنا الدواء من أعشاب الذاكرة؟ - جيهان أبوزيد

صيدليات الأرض المحاصَرة: كيف تصنع نساؤنا الدواء من أعشاب الذاكرة؟
عندما تتحطم صيدليات المدن تحت القصف، وتتحول المستشفيات إلى أهداف عسكرية، تخرج من رحم الأرض صيدلية أخرى، قديمة وجديدة في آن واحد. إنها المعرفة التقليدية التي حملتها النساء في الذاكرة عبر الأجيال، لا في كتب مغلقة أو مختبرات محصنة. في غزة، حيث يصبح الدواء سلعة سياسية تحت الحصار، تتحول ورقة الزعتر إلى وصفة مقاومة، والخبيزة إلى درس في السيادة الغذائية، ونبتة العكوب إلى صيدلية كاملة في ساق وأوراق. النساء هنا لا يمارسن "طباً بدائياً" بل يحفظن نظاماً معرفياً كاملاً، يربط بين نبض الجسد وإيقاع الأرض، بين ألم الإنسان وحكمة النبات.
عبر التاريخ، لم تكن الحروب مجرد صراع على الأرض والموارد، بل كانت أيضاً صراعاً على الجسد البشري وحقه في الحياة والصحة. في مواجهة هذه الآلة القمعية، طوَّرت المجتمعات المحاصَرة والمستَعمَرة أدوات خفية للمقاومة، كان أبرزها الحفاظ على نظمها الطبية التقليدية واستخدامها. هذه الممارسة لم تكن مجرد بديل ضروري عن غياب العلاج الحديث، بل كانت شكلاً عميقاً من أشكال التحدي والسيادة الثقافية.
إن احتكار الطب الحديث، خاصة في عصر الاستعمار والحروب الشاملة، لم يكن محايداً؛ فغالباً ما جُعِلَ أداةً للهيمنة، حيث اعتُبرت المعارف الطبية المحلية "بدائية" لتحل محلها أنظمة المستعمِر التي فرضت تبعية مزدوجة: جسدية وثقافية. ومن هنا، كان التمسك بالطب التقليدي والاستمرار في ممارسته تحت وطأة الحرب أو الاحتلال بمثابة خط دفاع أول عن الهوية والاستقلالية. إنه مقاومة مزدوجة: ضد المرض الذي ينشره الدمار، وضبط النظام المعرفي المهيمن الذي يسعى لإخضاع العقل والجسد معاً.
ظهرت هذه الممارسات جلية في سياقات عدة: أثناء حروب التحرير ضد الاستعمار: كالمقاومة الجزائرية التي اعتمدت على الطب الشعبي والعشبي لعلاج المجاهدين في ظل شح الإمدادات الطبية الحديثة، محوِّلة المعرفة المحلية إلى سلسلة تموين طبية سرية تعمل خارج سيطرة المستعمِر الفرنسي.
في مجتمعات الأقليات المضطهدة والمجتمعات الأصلية: كالسكان الأصليين للأميركتين الذين حافظوا على أسرار النباتات الطبية وطقوس الشفاء كجزء من صراعهم للبقاء ثقافياً وجسدياً في مواجهة الإبادة والاستيعاب القسري. كانت معرفتهم بالأعشاب خطاً دفاعياً أخيراً لحماية مجتمعاتهم من الأوبئة التي جلبها المستوطنون.
تحت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا: حيث استخدمت المجتمعات السوداء المحرومة من الرعاية الصحية الكافية الطب التقليدي ليس فقط للعلاج، بل كوسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على كرامة مجتمعٍ جُرِّد من حقوقه الأساسية. وفي مواجهة تجارة الرق عبر الأطلسي: حيث حمل الأفارقة المستعبدون معهم بذور النباتات الطبية ومعارف العلاج عبر المحيط، محوِّلين هذه المعرفة إلى تراث مقاومة بيولوجي ساعدهم على النجاة في ظروف لا إنسانية، وكان شكلاً من أشكال نقل الوطن في جيبهم.
في العصر الحديث، يتحول الطب التقليدي من تراث ثقافي إلى درع وطني وشبكة بقاء استثنائية في سياقات الحروب والحصارات التي تٌشن على دول المنطقة.
فكما حوّلت النساء في غزة بيوتهن إلى صيدليات صغيرة تصنع المراهم من زيت الزيتون وتعالج الإسهال بالقابونية والرمان، وكما أعادت القابلات في اليمن إحياء معرفة الولادة الآمنة في المنازل بعد تدمير المستشفيات، وكما لجأت الأسر في السودان إلى مخزونها الوَرَاثي لمواجهة الملاريا والجروح، وكذا فعلت السودانيات والافريقيات المحاصرات في ليبيا تحت قبضة الميلشيات المسلحة حيث يستعملن مسحوق نبات السدر (النبق) الممزوج بالماء كعلاج تقليدي للالتهابات الجلدية والأمراض الجلدية الشائعة في ظروف الاكتظاظ وسوء النظافة.
كما تصنعن كمادات البصل المحمص أو زيت الحبة السوداء لعلاج آلام الأذن والتهابات الجهاز التنفسي.
وفى سوريا – التي لم تخرج كلياً من أتون الحرب – والتي انهار نظامها الصحي بفعل الحرب، مارست النساء الطب التقليدي على مستويين: ففي المنزل، تحول المطبخ إلى مختبر حيث يُعالج التهاب الجهاز التنفسي بالزعتر البري، وتُضمّد الجروح بالعسل وحبة البركة، ويُحارب سوء التغذية بـ"مكعبات الحياة" المصنوعة من القمح المنبت والتمر.
وعلى المستوى المجتمعي، تشكلت شبكات نسوية في المناطق المحاصرة، مثل الغوطة الشرقية، حوّلت بعض البيوت إلى مراكز ولادة وإسعاف أولي، تعتمد على تعقيم الأدوات على النار واستخدام الأعشاب المهدئة كالبابونج والزهورات للسكنة الجسدية والنفسية معاً.
إن فعل صنع الدواء من أعشاب الأرض في سوريا وغزة واليمن والسودان هو، في جوهره، رفض صارخ لجعل الموت قراراً سياسياً بيد المحاصِر أو القاصِف، وإعلان أن إرادة الحياة قادرة على استخراج أدواتها حتى من تحت الأنقاض، محوّلة المعرفة التقليدية إلى فعل تحرّر وسلاح مقاومة يخلق الخلاص اليومي بيدي أهله.
هذه الممارسات ليست تراجعاً إلى الماضي، بل هي استعادة نشطة للسيادة على الجسد والحياة، وهي إبداع قسري يُحوّل الذاكرة التراثية إلى خط دفاع وجودي. إن فعل صنع الدواء من أعشاب الأرض في سوريا وغزة واليمن والسودان هو، في جوهره، رفض صارخ لجعل الموت قراراً سياسياً بيد المحاصِر أو القاصِف، وإعلان أن إرادة الحياة قادرة على استخراج أدواتها حتى من تحت الأنقاض، محوّلة المعرفة التقليدية إلى فعل تحرّر وسلاح مقاومة يخلق الخلاص اليومي بيدي أهله.
ذاكرة الأرض التي ترفض النسيان
هذه المعرفة ليست مجرد بديل مؤقت، بل هي ذاكرة الأرض التي ترفض النسيان. ففي السودان، حيث حولت مشاريع الزراعة الكبرى الأرض إلى سجلات مالية في بنوك بعيدة، تحتفظ النساء في جرار خزفية صغيرة بذاكرة أخرى للتربة. كما حدث في لبنان أثناء الحرب الأهلية، عندما خبأت النساء بذور النباتات تحت الفراش ككنز لا يقدر بثمن، أصبحت هذه البذور اليوم أرشيفاً حياً يحمل شفرات البقاء: أي صنف يتحمل الجفاف، وأي بذرة تنمو دون مياه كثيرة، وأي نبتة تشفي دون أن تطلب إذناً من شركة دواء عالمية. هذه البذور تتذكر ما نسيناه: أن الأرض تعرف كيف تداوي نفسها، والنبات يعرف كيف يتكاثر دون براءات اختراع.
لكن المعرفة لا تبقى حبيسة الذاكرة الفردية. إنها تتحول إلى عملة تضامن في اقتصاد الظل. في سراييفو المحاصرة، حيث تحولت الحياة إلى حصار داخل الجدران، أصبحت معرفة النساء في حفظ الطعام وتخزينه وتجفيفه نظاماً اقتصادياً موازياً أنقذ آلاف الأرواح. لم تكن مجرد "نصائح منزلية"، بل كانت شبكة معرفية سرية تعمل بقواعد التضامن: من تعرف كيف تخزن البطاطس في الرمل الجاف تنقل سرها إلى عشر عائلات، ومن تكتشف طريقة لطهي الحبوب دون وقود تكتب وصفتها على أوراق توزع كمنشورات ثورية. كانت الوصفات تنتقل بين الشقق المحاصرة كرسائل مقاومة، وكان تخمير الخضار في الجرار يصبح درساً في الكيمياء الحيوية للفقراء.
هذا الاقتصاد المعرفي الموازي يتكرر اليوم في جغرافيات الألم المختلفة. في دارفور، حيث تُسرق المساعدات أو تُحتجز، حوّلت النساء تقنيات التجفيف التقليدية إلى هندسة بقاء. مخازن تحت الأرض تحفظ الحبوب من النهب، تقنيات تعتيق اللحوم والشمس تحولها إلى رصيد غذائي لأشهر، معارف في نباتات الصحراء التي تنقي المياه تصبح مورداً لا ينضب. كل هذا لا يُدرس في مدارس، بل يتناقل في همس بين النساء في طوابير المياه، أو في أغاني يحفظها الأطفال وكأنها أناشيد وطنية لحماية الحياة.
والأعمق أن هذه المعرفة تتحول إلى سلطة سياسية مصغرة. المرأة التي تعرف كيف تستخرج المضاد الحيوي من نبتة برية، لا تملك حلاً طبياً فحسب، بل تملك قراراً حول من يعيش ومن يموت. المرأة التي تحفظ بذور الأصناف المحلية، لا تحفظ تنوعاً زراعياً فقط، بل تحفظ استقلالاً غذائياً لمجتمعها. في هذه المعرفة تصبح المرأة حارسة للسيادة، لكن سيادة من نوع مختلف: سيادة على القدرة على الاستمرار، على معرفة خلق الحياة من أدوات بسيطة، على رفض الاقتلاع من جذور الأرض والذاكرة.
هذه الشبكات المعرفية التي تمتد من خيمة في غزة إلى كوخ في دارفور، ومن شقة في سراييفو إلى دار في طرابلس، هي في الواقع جذور تنمو تحت أنقاض الحروب. إنها تحمل ذاكرة النظام البيئي الكامل الذي كان موجوداً قبل أن تطأه الدبابات:
نظام يعرف كيف يشفي نفسه، يطعم نفسه، يحفظ تنوعه البيولوجي والثقافي. والنساء هنا هن البستانيات الخفيات لهذا النظام، ينقلن البذور في طيات الثياب، ويكتبن الوصفات على هوامش الكتب المدرسية، ويحفظن أسماء الأعشاب كما يحفظن أسماء أطفالهن.
تذكرنا هذه المعرفة التقليدية بأن أعمق أشكال المقاومة ليست بالضرورة تلك التي تواجه الموت، بل تلك التي تتذكر باستمرار كيفية خلق الحياة. وعندما تتحول ورقة نبات إلى صيدلية، وبذرة محلية إلى بنك وراثي، ووصفة جدة إلى خريطة بقاء، فإننا نكتشف أن الحرب، رغم كل دمارها، فشلت في قتل شيء واحد: ذاكرة الأرض، وحكمة الأيدي التي تعرف كيف تعتنى بها.
تفكيك مقومات الحياة:
إن الحرب في جوهرها ليست مجرد صدام عسكري عابر، بل هي الامتداد العنيف والمكثف للقمع البنيوي الذي يسبقها بسنوات؛ فهي اللحظة التي ينتقل فيها الظلم من شكل "القوانين والإقصاء" إلى شكل 'الرصاص والدمار'. يرى فوكو أن السلطة الحديثة لا تكتفي بفرض القوانين، بل تمارس قوتها من خلال التحكم في جسد الإنسان وحياته. في زمن الحرب، يتحول هذا التحكم إلى ما يمكن تسميته سياسة الموت، حيث تقرر القوى القامعة—عبر تدمير المستشفيات ومنع الدواء—من هو الجدير بالحياة ومن يُترك للموت.
لا تقف الحرب عند حدود تعطيل الرعاية الصحية، بل هي عملية تفكيك ممنهج لكل مقومات الحياة، تهدف إلى تحويل الوجود الإنساني إلى 'مجرد بقاء' عارٍ من أي ضمانات. هذا الانقضاض الشامل هو الذروة المادية لسنوات من القمع البنيوي الذي جعل هذه المجتمعات مكشوفة وهشة سلفاً. وفي هذا السياق، تتجاوز 'السياسة الحيوية' عند فوكو معناها الإداري لتصبح سلطة قاهرة تمارس 'حق الإماتة' عبر تدمير البيئة الحيوية للإنسان. ومن رحم هذا الدمار الشامل، تبرز المعرفة التقليدية التي تقودها النساء ليس كخيار طبي، بل كـ فعل استرداد للوجود. فعندما تستخدم المرأة في غزة أو اليمن أدوات بدائية للشفاء، هي في الحقيقة تعيد بناء 'معنى الحياة' في مواجهة آلة تهدف إلى محوه كلياً. إنها تحول الجسد من هدف مستباح للقمع البنيوي إلى ساحة للمقاومة الأصيلة، محاولةً خلق 'سيادة شعبية' على البقاء حين يقرر العالم سحب كل مقوماته.
في الحروب الراهنة (غزة، السودان، اليمن)، نلاحظ أن التدمير لا يطال المستشفى كبناء فقط، بل يطال "المقومات الأولية" التي تسبق المستشفى. عندما يتم تجريف الأراضي الزراعية، وقصف محطات تحلية المياه، وقطع خطوط الطاقة، نحن أمام عملية "تجريد" متعمدة للإنسان من وسائله البدائية للبقاء. وهو قمع يسعى لجعل الأرض نفسها "عدواً" لقاطنيها، بحيث لا يجد الإنسان ماءً يشربه ولا أرضاً تمنحه الغذاء.
هنا يبرز مفهوم فوكو بشكل عميق فآلة الحرب لا تكتفي بالرقابة، بل تمارس "تأميم الحياة". يصبح الحصول على "ليتر ماء" أو "رغيف خبز" أو "جرعة أنسولين" فعلاً سياسياً يتطلب الخضوع أو انتظار الإذن من القوة القامعة. هذا التجريد يحول الإنسان من "مواطن له حقوق" إلى "كائن بيولوجي محاصر" في أدنى مستويات سلم الاحتياجات. القمع البنيوي هنا يهدف إلى "كسر الإرادة عبر إرهاق الجسد"؛ فحين يقضي الإنسان يومه بالكامل في البحث عن حطب للتدفئة أو ماء ملوث للشرب، يتم استنزاف طاقته الذهنية والسياسية، مما يجعله عاجزاً عن التفكير في أي مشروع للمقاومة أو التغيير.
الحرب تجرد الإنسان أيضاً من "زمنه". القمع البنيوي يجعلِ المواطن /المواطنة تعيش في حالة "انتظار" دائم،انتظار المعونة، انتظار فتح المعبر، انتظار عودة الكهرباء, إنتظار الغذاء, انتظام الصغار ليناموا ببطون فارغة . هذا التجريد الزمني هو جزء من هندسة القمع؛ إذ يتم إيقاف نمو المجتمع وتطوره، وإعادته عقوداً إلى الوراء. تصبح الاستجابة النسائية عبر الطب التقليدي هنا ليست مجرد "علاج"، بل هي محاولة لـ "استرداد الزمن" واسترداد القدرة على الفعل بعيداً عن انتظار "المُستعمِر" أو "القوة القامعة" لكي تمنح الإذن بالحياة.
لا يمكن اذن اختزال الحرب في كونها تعطيشاً أو تجويعاً عارضاً،او استباحة للأجساد والممتلكات والأرض والموارد, بل هي عملية تجريد بنيوي شامل تهدف إلى نزع صفة 'القابلية للحياة' عن الفضاء الإنساني. إنها اللحظة التي ينتقل فيها القمع من 'حرمان إداري' إلى 'محو مادي' لكل العناصر التي تضمن بقاء الجسد؛ من الماء النقي إلى التربة المنتجة وصولاً إلى الهواء الصالح للتنفس. هذا التجريد الممنهج يحول مقومات الحياة الأساسية إلى أدوات للضبط السياسي، حيث تصبح لقمة العيش وقطرة الماء وسائل لابتزاز الوجود. وفي مواجهة هذا المسعى لتحويل الإنسان إلى 'كائن هش' بلا حول، تبرز المعرفة التقليدية التي تقودها النساء كفعل تمرد على التجريد؛ إنها محاولة لاستنبات البدائل من ذات الأرض التي يراد لها أن تيبس، واستعادة لسيادة الجسد عبر أدوات أصيلة ترفض الانصياع لمنطق الإماتة الممنهجة. هو تماما ما تفعله النساء في تلك اللحظات.
إن لجوء النساء في غزة واليمن والسودان وسوريا من قبل إلى الطب التقليدي ليس مجرد تدبير عملي للتعامل مع ندرة الدواء، بل هو إعلان صامت عن استعادة السيادة على الجسد والحياة من براثن سلطة قررت إمّا قتله إهمالاً بالحصار أو إفنائه قصفاً. هذا الفعل يحمل في طبقاته معاني متشابكة: فهو من جهة استحضار لتراثٍ عابر للأزمنة، ليس كمجرد وصفاتٍ جامدة بل كذاكرة جماعية حية للصمود، تحمل في جذور الأعشاب وأسرار التحضير حكاية تكيُّف الأسلاف مع الأزمات، وتشكّل نظاماً معرفياً مستقلاً يتحدى هيمنة الأنظمة الطبية الرسمية المرتبطة بسلطة المستَعمِر أو المحاصِر.
وهو من جهة أخرى ثمرة لتلك التنشئة الاجتماعية التي تهيئ المرأة، رغم كل قيودها، لتكون أخصائية في إدارة الندرة وقائدة غير معلنة في أوقات الشدة، حيث تتحول مهارات الرعاية المنزلية إلى كفاءات استراتيجية للبقاء، وتتحول الشبكات النسوية غير الرسمية إلى هياكل تنظيم موازية تتبادل المعرفة وتنسج خيوط الأمان المجتمعي.
وفي الصميم، يتجاوز هذا الفعل ثنائية الفطرة مقابل الثقافة؛ فغريزة البقاء البشرية الجامحة لا تظهر هنا كدافع فردي للهرب أو الاختباء، بل تُسخَّر وتُوجَّه نحو فعل إبداعي جماعي. إنها حكمة عملية تولد من إلحاح الجوع وألم المرض، فتخرج من مخزون الذاكرة التراثية والمهارات التنظيمية اليومية.
وهكذا، في اللحظة التي يتحوَّل فيها الجسد بواسطة آلة الحرب إلى ساحة للموت البطيء أو السريع، تأتي ممارسة الطب التقليدي كفعل تحريري يجسد ما يمكن تسميته "بالسيادة الحيوية": أي استعادة السيطرة على عمليات الحياة الأساسية من التغذية والشفاء إلى الولادة والعاطفة، باستخدام الموارد المحلية والمعرفة المستقلة.
إن صنع مضاد حيوي من أعشاب الأرض، أو توليد حياة جديدة في قبو تحت الأنقاض، هو رفض صارخ لأن يكون الجسد مجرد مختبر سلبي لتجارب القمع، وإعلان بأن الحياة ليست ردة فعل على قرار خارجي بالموت، بل هي مشروعٌ خلاق تُنتِجه إرادة المقاومة.
هذه الممارسات ليست "تراجعاً" إلى الماضي، بل هي تقدم نحو الداخل، نحو استخراج الموارد من الذاكرة الجماعة ومن تربتها. إنها تثبت أن آخر خطوط الدفاع عن الحياة ليس في المستودعات الدولية للإغاثة، بل في معرفة الأجداد التي تختزن طرق استخلاص الدواء من البابونج والزعتر والصبار. وهكذا، يتحول الطب التقليدي من تراث ثقافي إلى استراتيجية بقاء وسلاح مقاومة، يُعيد للإنسان المحاصَر سيطرته على أكثر ما تهدده آلة الحرب: جسده وحقه الأساسي في الصحة والعناية.
احدث المنشورات
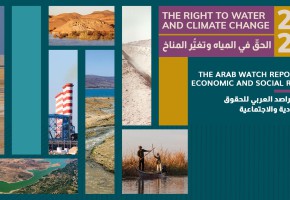
2025 - راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، الحق في المياه وتغيّر المناخ
