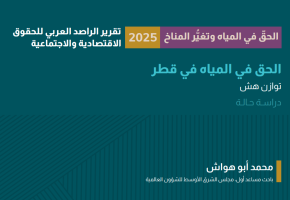صندوق النقد الدولي في المنطقة العربية: سرديات الإصلاح ومآزق السياسة - حسن شري

صندوق النقد الدولي في المنطقة العربية: سرديات الإصلاح ومآزق السياسة - حسن شري
"لم يعد هناك فرق بين الاقتصاد والسياسة، لأن اللغة نفسها
تسود في كليهما، من طرف إلى آخر..."
جان
بودريار - فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي
يلعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريًا في هندسة السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية، ولا سيما منذ بداية العقد المنصرم مع تنامي موجات الحراك الشعبي. لكن مع تصاعد وتيرة التقلبات الاقتصادية والمالية والأزمات الاجتماعية التي خلّفتها تلك التحولات، ترسّخ في الوعي الإقليمي تصوّر نقدي حيال دور الصندوق، يستند إلى اعتباريْن أساسييْن: أولًا، إخفاق الصندوق في تحقيق توازن فعلي بين متطلبات الاستقرار المالي وضرورات العدالة الاجتماعية، رغم تبنّيه خطابًا جديدًا يهدف إلى تعزيز النمو الشامل وتوسيع الحيز المتاح للسياسات الوطنية لمواجهة الأزمات التنموية؛ وثانيًا، غياب الاتساق في معايير الإقراض، إذ تطغى أحيانًا الاعتبارات الجيوسياسية التي تفضي إلى مرونة في الشروط، بينما تُفرض في حالات أخرى برامج تقشفية صارمة دون اكتراث كافٍ بالآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
تمّت مناقشة هذه الإشكالية، المتمثلة في الفجوة بين خطاب الصندوق وسياساته الفعلية، وكذلك عدم تجانس معايير الإقراض بين دول المنطقة، بشكل واضح خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنتدى سياسات المجتمع المدني (CSPF) في أبريل 2025 بواشنطن، من قِبل مختلف الأطراف المشاركة، ولا سيما منظمات المجتمع المدني. وخلال الجلسات التي تناولت أوضاع الدول العربية، طُرحت تونس ومصر والأردن كأمثلة بارزة على هذه التناقضات.
في تونس، وبعد سنوات من التعاون مع صندوق النقد الدولي، عبّرت البلاد عن استيائها من السياسات المفروضة التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاجتماعية، لتبلغ ذروتها بإعلان فك الارتباط مع الصندوق ورفض شروطه المتعلقة بخفض الدعم وتقليص الإنفاق العام. في المقابل، تُبرِز حالة مصر كيف يمكن للاعتبارات الجيوسياسية أن تطغى على المعايير الاقتصادية، إذ حصلت على قروض ضخمة، منها قرض بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، وتوسيع قرض آخر إلى 8 مليارات دولار في أواخر 2024، رغم التحديات الهيكلية واستمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس رغبة القوى الدولية في الحفاظ على استقرار مصر باعتبارها حليفًا إقليميًا مهماً. أما في الأردن، فقد تضمّنت برامج التكيّف الهيكلي التي أُقرّت ضمن اتفاقيات التمويل إجراءات تقشفية قاسية، شملت رفع الدعم وزيادة الضرائب، بينما ظلت تدابير الحماية الاجتماعية المحدودة غير قادرة على احتواء آثارها بسبب ضعف القدرات المؤسسية.
تجادل هذه المقالة بأن أسباب هذه الازدواجية تعود إلى عامليْن رئيسييْن: أولًا، أن وظائف الصندوق تمثل انعكاسًا مباشرًا للتحولات الجيوسياسية؛ وثانيًا، البعد المؤسسي، حيث يتأثر الصندوق بجملة من الضغوط الداخلية والخارجية التي تشكل توجهاته وسياساته.
الجغرافيا السياسية المتغيرة وإعادة تشكيل وظائف الصندوق
تعكس وظائف الصندوق بوضوح التحولات الجيوسياسية، خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي ومع انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث برز توجه غربي يربط بين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الديمقراطية. وقد ظهر هذا التوجه في برامج الصندوق التي ركّزت على الحوكمة الرشيدة والشفافية، فيما ظل البعد الجيوسياسي عاملًا حاسمًا في توجيه سياسات الإقراض. ففي العديد من الحالات، خُففت شروط الصندوق لخدمة مصالح استراتيجية، كما حدث مع مصر وزائير (الكونغو الديمقراطية حاليًا) خلال الحرب الباردة، حيث جاء الدعم مدفوعًا بضغوط سياسية لضمان الاستقرار، بينما غابت الإصلاحات الاقتصادية الفعلية، وفقًا لبوردو وجايمز (2000)1.
هذا النمط لا يزال قائمًا حتى اليوم، كما يتضح في حالة مصر بعد حرب غزة 2023، حيث سارع الصندوق إلى توسيع برنامج الإقراض رغم أزماتها الاقتصادية المزمنة. ويواصل الصندوق انتقاد الفساد والممارسات غير الديمقراطية في الدول الصغيرة، بينما يتعامل بحذر مع القوى الكبرى، مما يعزز فكرة أن البعد الجيوسياسي أصبح جزءًا أصيلًا من سياساته.
جانب آخر يعزز ارتباط سياسات الصندوق بالاعتبارات الجيوسياسية هو موقفه المتحفظ تجاه تصاعد الحروب التجارية وعودة السياسات الحمائية، خاصة بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. فرغم أن الصندوق يروّج دائمًا لتحرير التجارة وفتح الأسواق باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي، إلا أنه يتجنب اتخاذ مواقف حادة أو التصعيد عندما تصدر السياسات الحمائية عن الدول الكبرى ذات النفوذ داخل الصندوق. في المقابل، يفرض الصندوق بشدة شروط تحرير التجارة على الدول النامية ضمن برامجه الإصلاحية. هذا التباين يبرز مجددًا ازدواجية المعايير، ويؤكد أن وظيفة الصندوق لا تنفصل عن السياق الجيوسياسي العالمي.
بين الخطاب والممارسة: فجوة مستمرة وتناقضات مؤسسية
منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، أعلن صندوق النقد الدولي عن مراجعة لسياساته، مؤكدًا أهمية السياسات المضادة للدورات الاقتصادية، مثل الإنفاق التوسعي وتعزيز دور الدولة في التحفيز الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. إلا أن التجربة العملية في الدول العربية لم تُظهر سوى تغييرات محدودة، حيث حافظ الصندوق على نهجه التقليدي، كما يتضح من حالات مصر وتونس والأردن، التي خضعت لإجراءات تقشفية شملت رفع أسعار الطاقة والضرائب، ما فاقم معدلات الفقر والبطالة.
يفسّر كينتيكيلينيس وآخرون (2016)2 هذا التناقض باعتباره ناتجًا عن مزيج من الحفاظ على النموذج الأساسي للصندوق و"النفاق المنظم" الذي يميز عمل البيروقراطيات الدولية. فصندوق النقد الدولي، كمنظمة دولية معاصرة، يمثل مساحة غنية بالتناقضات، إذ يواجه ضغوطًا متعددة من المساهمين والمديرين التنفيذيين، إلى جانب الأجندات البيروقراطية والتكنوقراطية الداخلية، فضلًا عن الرأي العام. هذا التفاعل بين الضغوط الخارجية والداخلية يؤدي إلى انفصال بين الأهداف المعلنة في الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية. واستجابةً لهذه الضغوط، يلجأ الصندوق إلى ما يُعرف بـ"النفاق المنظم"، الذي يُعد، وفقًا للأدبيات، ضروريًا لضمان استمرار المؤسسة في أداء دورها ضمن النظام المالي العالمي.
ملاحظة ختامية
تُظهر التجارب المتكررة مع صندوق
النقد الدولي الى أن عدم التواؤم بين الخطاب والممارسة بالإضافة الى إشكالية تسييس
القرارات باتت مسألة هيكلية وليست مجرد استثناءات ظرفية. هذه الممارسات تؤكد أن
المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، باتت بحاجة
إلى إصلاح جذري يعيد ضبط دورها ضمن منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. من هذا المنطلق،
دعت منظمات المجتمع المدني، في إطار عملية تمويل التنمية (Financing
for Development)، إلى إعادة إخضاع صندوق
النقد والبنك الدولي إلى مظلة الأمم المتحدة لضمان خضوعهما لمبادئ الشفافية
والمساءلة الديمقراطية، وللتأكد من أن سياساتهما تتماشى مع أهداف التنمية
المستدامة وحقوق الإنسان، بعيدًا عن الهيمنة الجيوسياسية لمجموعة محدودة من الدول.
معالجة هذه القضايا النظامية أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لضمان نظام
اقتصادي عالمي عادل ومتوازن يخدم مصالح الشعوب كافة.
[1] Bordo, M.D. and James, H., 2000. The
International Monetary Fund: its present role in historical perspective.
Available at: http://bit.ly/3x8X8ab
[2] Kentikelenis, A.E., Stubbs, T.H. and
King, L.P., 2016. IMF conditionality and development policy space, 1985–2014.
Review of International Political Economy, 23(4), pp.543-582. Available at: https://bit.ly/3RSdPQt
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة